فقوله تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ}
تضع القارئ منذ البداية أمام حقيقة أن ما سيتلوه وما تلاه ليس من الأخبار البشرية، بل من الغيب المحض الذي اختص الله به نفسه، ثم أطلَع منه ما شاء على رسوله الكريم ﷺ.
ومن ذلك قوله تعالى:
{وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (آل عمران: 44)
يكشف مشهدًا داخليًا في الهيكل، تحرّك فيه الأحبار لإلقاء أقلامهم لتحديد من يكفل مريم. وهذا تفصيل لا يمكن للبشر الوصول إليه، ولا الاطلاع عليه، لأنه يجري داخل مجمع مغلق لا يشهده أحد إلا أهله.
وكذلك قوله سبحانه:﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ (القصص: 44)
{وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا} (القصص: 46)
إشارة واضحة إلى أن قصة موسى ليست من أحداث الجزيرة، ولا من القصص المتداولة عند العرب، ولا من علم أهل مكة، ومع ذلك جاء القرآن بتفصيلاتها الدقيقة.
ومن هذا الباب قوله تعالى في قصة يوسف: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَمْكُرُونَ} (يوسف: 102) وهو مشهد من الغيب الخالص؛ مكر وقع سرًّا بين الإخوة، في ظلمة بئر، وفي مجالس لم يحضرها إلا أصحابها، ومع ذلك أخبر الله نبيه بتفاصيله وكشف دخائل النفوس فيه. ثم تأتي الآية العجيبة في السورة نفسها:
{وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ{ (يوسف: 23)
لتصوّر موقفًا مغلقًا لا يراه بشر، وتكشف ما دار خلف الأبواب وما كان في خواطر النفوس، تصويرًا لا يكون إلا عن وحي من العليم الخبير.
هذه الآيات—وأمثالها—تقدّم برهانًا قاطعًا على المصدر الرباني للقرآن؛ إذ إن أصل القصص معروف لدى أهل الكتاب ولا مجال لإنكار وقوعه، لكن تفاصيله الدقيقة—التي لا يعرفها إلا الله—هي التي جاء القرآن بها ليكون ناطقًا بالحق، شاهدًا على صدق الرسالة، ومهيمنًا على ما بين يديه من الكتب السابقة. فما أخبر به القرآن من الغيب الماضي، وما كشفه من دقائق التاريخ البعيد، هو دليلٌ لا يقبل الرد، ولا يملك المنصف أمامه إلا التسليم؛ لأن النبي ﷺ لم يشهد تلك الوقائع، ولم يتلقّها عن بشر، وإنما جاءت إليه من رب العالمين.


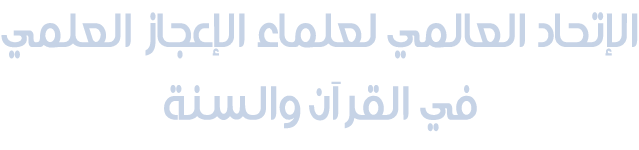

 الإيمان والدين
الإيمان والدين





 الطبيعة وعلم الأحياء
الطبيعة وعلم الأحياء


 اللغة والنحو
اللغة والنحو